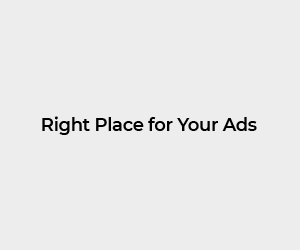الحدث بريس : متابعة
مع اعتماد نمط التعليم عن بعد خلال جائحة فيروس كورنا المستجد، طفا من جديد النقاش حول الصعوبات التي تواجهها فئات من الأطفال وجدت عناء كبيرا في التكيف مع هذا النمط، بسبب الإضطرابات النفسية والسلوكية والتعلمية التي يعانون منها.
ومن هؤلاء الأطفال الذين لديهم اضطراب صعوبة التعلم، الذي تعرفه الجمعية الكندية لصعوبة التعلم بكونه عبارة عن مجموعة من الاختلالات الوظيفية، التي يمكن أن تمس امتلاك وتعلم واستيعاب وفهم ومعالجة المعلومة اللفظية وغير اللفظية.
وهذه الاختلالات، التي تعوق قدرة الطفل على استيعاب ما يراه وما يسمعه، والتي غالبا ما يتم تشخيصها في سياق البحث عن أسباب الفشل الدراسي المتكرر، تشمل اللغة اللفظية (التلقي والتعبير)، واللغة المكتوبة، والقراءة (التعرف على الكلمات وفهمها)، والكتابة (الإملاء، التعبير الكتابي)، والرياضيات (الحساب، التفكير المنطقي، وحل المسائل الرياضية).
وبهذا الخصوص، أوضحت المدربة المعتمدة في التنمية والمهتمة بمجال التربية والتعليم “منى الصباحي”، على أن “الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم ونمط التعليم عن بعد”، أن صعوبات التعلم تظهر على الأطفال من سن ست سنوات فما فوق، وما دون هذه العمر يستحيل الحديث عنها، إذ خلال مرحلة ما قبل ست سنوات يكون الطفل في مرحلة النمو الحركي، ما يسمى بـ (psychomotricité fine)، أي بداية تعلم تقنيات الكتابة والقراءة والتركيز.
غير أنه من الملاحظ، تضيف هذه المدربة، أن الآباء عندما يلحقون أبناءهم بالحضانات أو بالمدارس في سن ثلاث أو أربع سنوات يكون أفق انتظارهم كبيرا، ويتوقعون من أبنائهم الصغار أن يجيدوا في كل ما يطلب منهم من كتابة وقراءة وحساب، وفي حال لم يرق الطفل إلى مستوى توقع الأسرة، يتم نعته بالكسل أو الخمول، أو أنه مصاب بأحد الاضطرابات كفرط الحركة والتوحد.
مع أنه في الوقت الذي يوجد فيه أطفال بإمكانهم التأقلم مع محيطهم الدراسي، هناك أطفال آخرون ليست لهم القدرات نفسها، تستطر المتحدثة ذاتها، وهو ما لا يريد مجموعة من الآباء أن يقتنعوا به ويسارعون إلى إطلاق الأحكام على أبنائهم، قائلا “إن ابني يعاني من فرط الحركة” أو “ابني مصاب بالتوحد”، مع أن فرط الحركة والتوحد هي اضطرابات تستدعي التشخيص من قبل متخصصين في المجال.
وتؤكد الصباحي، في هذا الاتجاه، أن مستويات الذكاء عند الأطفال متفاوتة، وطريقة تفاعلهم وتواصلهم مع المحيط متباينة، ومن الطبيعي أن يكون هناك أطفال حركيون أكثر من أقرانهم، أو وتيرة تعلمهم أدنى من الآخرين، دون أن يعني ذلك أنهم مصابون باضطراب فرط الحركة أو التوحد.
وتشدد على أن المتخصص هو المخول الوحيد للقيام بالتشخيص وتحديد طبيعة الصعوبة لدى الطفل ونوعها، فلا يمكن الحكم على أي طفل يجد صعوبة في الكتابة أو القراءة أو يتعلم بوتيرة أبطأ من زملائه، أو يعاني مشكلا ما على مستوى التركيز والتواصل والتفاعل مع المعلم، بأن لديه اضطراب صعوبة التعلم، مشيرة إلى أن صعوبات التعلم (TA) تختلف عن الاضطرابات المتمثلة في ضعف القدرة على التركيز أو فرط الحركة (TDAH).
وهو ما تؤكد عليه الجمعية الكندية لصعوبات التعلم، والتي تلح على أن يتم تشخيص هذه الاضطرابات في وقت مبكر، عبر جلسات منتظمة للتقييم من قبل مختصين، لمساعدة الطفل على تجاوزها، بتعاون بين الآباء والمدرسة والمحيط، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز هؤلاء الأطفال عن أقرانهم.
فللآباء والمربين دور كبير في مساعدة وتحفيز هذه الفئة من الأطفال لتتأقلم مع هذه الصعوبات، وتتمكن من تجاوزها، وذلك من خلال مواكبة الطفل والانتباه إلى طريقته في التعلم لرصد أي قصور أو خلل، فعندما يلاحظ مثلا أن الطفل يجد صعوبة في تلقي المعلومة، أو هناك بطء في استيعابها، أو له مشاكل في النطق أو الكتابة أو تأخر عن مستوى القسم، يتم استشارة أخصائي في الموضوع لتحديد نوع الصعوبة، بعيدا عن التشخيصات الذاتية التي يمكن أن تؤدي إلى خلاصات خاطئة.
فهؤلاء الأطفال يحتاجون، بحسب الجمعية الكندية، إلى مواكبة تضمن تعليما مدمجا، واعتماد برامج دعم متكاملة وملائمة لطبيعة الصعوبات التي يعانون منها، وتطوير قدراتهم الذاتية واستثمارها ليستعيد ثقته في مؤهلاته، ومساعدته على الاندماج الجيد ضمن محيطه الدراسي والاجتماعي.
فالمطلوب إذن، برأي الصباحي، البحث الدائم والتعرف على هذه الاضطرابات عن قرب، لاختيار الأساليب التعليمية الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطفل، بل والابتكار فيها، خاصة أنه في ظل الجائحة أصبح هناك انتشار كبير للمعلومة وهي اليوم متاحة بأكثر من لغة.
وعبرت عن أسفها لكون الآباء، أحيانا، يقومون بوصم الطفل بنعوت من قبيل “أنت مكلخ” أو “انت كسول” أو “مالك مكتفهمش”، وهنا حتى إن كان الطفل لا يعاني من أي اضطراب، إلا أن هذه الوسوم (النعوت) تصير قناعات راسخة لديه، وتغير تمثلاته لذاته، فينشأ بداخله يقين بأنه فعلا عاجز عن الاستيعاب ولا يقدر على مواكبة أقرانه، وبالتالي يتصرف وفق هذه الصورة المغلوطة.
وأشارت إلى أنه إلى جانب سوء الفهم لحالة هؤلاء الأطفال من قبل الأسرة، هناك معضلة أخرى تزيد من وطأة معاناتهم، فهناك مدارس ترفض استقبال هؤلاء الأطفال، ما يعني إقصاءهم وحرمانهم من حقهم في التعلم، مما يمكنه أن يتسبب في خلق تشنج داخل المجتمع ككل.
واعتبرت أن هذه المواقف هي سلوكيات غير أخلاقية، وتنم عن أن مجتمعنا يرفض المختلف عنه، ويجد صعوبة في تقبل هذا الاختلاف أيا كان نوعه.
وتزداد حدة هذه الصعوبات جراء اعتماد نمط التعليم عن بعد، فهؤلاء الأطفال الذين غالبا ما يكون لديهم مشكل تشتت الانتباه، يجدون أنفسهم أمام شاشة وداخل محيط مليء بالمؤثرات التي تفقده القدرة التركيز أو التذكر، خاصة وأنه معتاد على وجود إطار بيداغوجي عام ينظم له عملية التلقي.
وتشير الصباحي إلى أنه إن كان من العسير على الأطفال عموما التكيف مع متطلبات التعليم عن بعد، فالأمر بالنسبة لهذه الفئة أكثر صعوبة، إذ من يشق عليهم مواكبة حصصهم الدراسية بغياب تواصل مباشر مع المؤطر أو الموجه، ويحتاجون مجهودا كبيرا لتحديد اتجاه تركيزهم، ومرافقة من قبل الآباء، علاوة على البحث عن طرق وحلول لتكييف العملية التعليمية مع احتياجاتهم الخاصة.
ومنها بالأساس توفير فضاء تعلم يتميز بالهدوء، وضبط مجال تحركه، ووضع مؤشرات (ألوان، ملصقات..) تذكر الطفل بما هو مطلوب منه، ومساعدته على وضع جدول أسبوعي للحصص، واختيار لون لكل مادة ضمن استعمال الزمن، وكلها تقنيات يمكن أن تساعده على استذكار المواد الدراسية وتوزيعها الزمني، وتحسين أدائه وتفاعله مع المؤطر.
ونوهت إلى أنه إن كان للتعليم عن بعد من إيجابيات، فمنها أنه أظهر وجود توتر وخلل في العلاقة بين الآباء والأطفال من جهة، وبين الآباء والمدرسة من جهة ثانية، إذ من خلال متابعة عملية التعليم لوحظ أن هناك آباء يتدخلون مباشرة أثناء بث الحصص الدراسية، بل ويحرجون أبناءهم أمام أساتذتهم وزملائهم مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على التوازن النفسي الطفل.
لتخلص إلى أنه لابد هنا من استشارة والاستعانة بمختصين أو مدربين في التربية أو خبراء في علم النفس التربوي لتأطير هؤلاء الأطفال بشكل جيد، إلى جانب العمل على مواكبة التعلمات والتطوير الذاتي لتسهيل العلاقة مع الطفل.
فصعوبة التعلم هي اضطراب وليست إعاقة، وبالتدريب والتفهم يتحول الطفل إلى شخصية ناجحة وواثقة، فالقراءة والكتابة والتواصل هي ذكاءات من بين أخرى متعددة، “فتعرفوا على هذه الذكاءات، واكتشفوها لتساعدوا طفلكم على تنميتها، ويصبح طفلا مبدعا في حياته الدراسية كما الاجتماعية”.