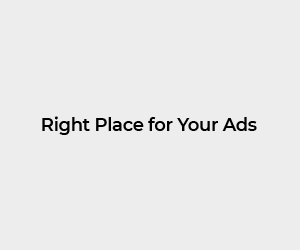في سورة واحدة، يظهر سؤالان يعلّمان الناس كيف يكون السؤال. سؤال مشروع لا تثريب عليه، وسؤال آخر هو عين الخطأ والاعتداء. في سورة البقرة نقرأ سؤال الملائكة، ونقرأ أيضا أسئلة بني إسرائيل.
عجيب جدا أن نعرف أن الملائكة المجبولة على الطاعة وعدم المعصية تتعجب فتسأل الله تعالى عن جعل آدم خليفة في الأرض. وجميل جدا أن الله تعالى لم ينهرها، ولم يعاقبها، و لم يتجاهل سؤالها، بل رد عليها ردا عمليا مفصلا. حين أبدى لها كيف أن آدم مهيّأ بالمعرفة {وعلم آدم الأسماء كلها …} التي تؤهله للخلافة.
وفي مكان آخر من السورة الشريفة، نجد سؤالا، أو بعبارة أدق السلسلة السؤالية التي صاغها بنو إسرائيل. سألوا، وسألوا، وسألوا. وأمهلهم الله ليمعنوا في السؤال ولم ينكر عليهم. تركهم ليضيقوا على أنفسهم بأنفسهم.
سؤال الملائكة كان سؤالا نبيلا، سؤالا استفساريا مشروعا. قد يبدو للعقل غير الخبير أنه سؤال ينم عن طمع، وحاشا أن يكون هذا من صفات الملائكة. لكن المنطق هو الذي فرض المقارنة بين الإنسان المعرض للمعصية وبين الملائكة التي لا تعصي ولا تستطيع ذلك. وإزاء هذا السؤال، أجاب الله وخلّد الموقف في القرآن ليعرف بنو آدم أن لا غضاضة من سؤال الملائكة، فما بالك بالبشر الذين يملكون النجدين؛ الطاعة والمعصية، بعكس الملائكة المجبولين على السير في طريق الطاعة وحده.
أما سؤال بني إسرائيل فكان سؤالا تنصليا، سؤال جدال ومراء و”شراء وقت”، كان محاولة لتمييع الموقف خوفا من كشف الحقيقة. فأخذوا يسألون ويسألون عن صفات البقرة، أملا في أن يتعذر إيجادها أو يتغير سير الأحداث إلى سيناريو أقل حدة من إحياء الميت وتوريط الجاني وأدانته إدانة تامة. كيف تعامل معهم الله تعالى؟ لم يقرعهم، ولم ينبههم أن يذبحوا أي بقرة وأن يتوقفوا عن الأسئلة، بل أمهلهم ليستدرجهم إلى تلك البقرة النادرة العزيزة التي كلفتهم مبلغا طائلا جعلهم يترددون في ذبحها حتى بعد أن وجدوها {… فذبحوها وما كادوا يفعلون}.
* * * * *
لا أعرف لماذا يرى البعض أن للإسلام صبغة معادية للسؤال والتساؤل. قد تكون ثقافتنا العربية قامعة له، لكن الإسلام شيء، وثقافتنا الخاصة شيء آخر. الإسلام حجة عليها، وليس العكس. والكم الهائل من الآيات التي تدعو للتفكر والتأمل لا يمكن إلا أن تأتي ضمن سياق دين لا يسمح بالسؤال وحسب، بل ويحث عليه ويبين أن من لا يتفكر عليه أن يفعل قبل أن يندم ساعة لا مندم. فكل هذا الحث على التفكر والنظر والتأمل وتقييم الوضع يستجلب معه بالضرورة الرغبة في السؤال والنقاش والمحاورة، وكل هذا مكفول.
هناك أسئلة الغرض منا الجدل أو المماطلة، هي أسئلة تنتحل شخصية شيء آخر، تظن نفسها في حفلة تنكرية. وكذلك، هناك شكاكين يألّهون الشك. لقد تحول السؤال والشك إلى وثن، واللايقين إلى صنم جديد في عصر ما بعد الحداثة. وهذا أخوف ما أخافه علينا!
تكررت عبارة “ويسألونك عن” في القرآن الكريم في مواضع عديدة في رد على أسئلة المسلمين وأيضا على أسئلة بعض أهل الكتاب، وقد أجاب المولى أسئلتهم. ولم يرد تقريع على السؤال إلا حينما يكون السؤال تنصليا كسؤال بني إسرائيل، أو حينما يتسبب في مشقة وتضييق. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (المائدة: 101) وهنا لا نجد النهي عن السؤال الاستفساري، بل عن السؤال الاستهزائي، وعن السؤال التضييقي الذي يجر على أصحابه ما لا داعي له أو كما نسميه بالعامية “منبّه اللوه”*!
سؤال موسى عليه السلام:
نحن مجبولون على السؤال، وقد أتمادى وأقول أننا أحيانا نكون مجبورين عليه. هذه النزعة المغروسة فينا نحو الفهم والتعقل لا تنمو إلا في تربة الأسئلة. وها هو سيدنا موسى عليه السلام، كليم الله لا يصبر أن لا يسأل. وفي قصته مع الرجل الصالح الواردة في سورة الكهف خير دليل. فالرجل الصالح حذر موسى عليه السلام قائلا: {وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً} (الكهف: 68). فتغلِب على موسى عليه السلام الطبيعة البشرية التي لا تصبر ولا تهدأ حتى تضع الأمور في نطاق يفهمه العقل، ححتى أنه نسي وعده للرجل الصالح. وفي المرة الثالثة، حين أدرك أن عليه ألا يسأل وفقا للوعد الذي قطعه على نفسه {قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا}، لم يطق ذلك، فخرج سؤاله بصيغة مواربة، على شكل نصيحة: {… قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً}. فالظاهر نصيحة يسديها، والباطن هو سؤال واستغراب. ونحن في هذه الواقعة لا نجد لوما من الله تعالى ليسدنا موسى على ما فعل، بل القرآن يوثق الحادثة وحسب ليبين لنا أن أسئلتنا مشروعة، لكن إجابة بعضها قد تكون علية عصية، وقدر الله لا يأتي إلا بحكمة. إنه يعلمنا كيف نتعامل مع بعض الأسئلة التي يطيش لها العقل، فيبلسم الأسئلة الشائكة التي قد تعترينا حينما تصفعنا الحياة ببعض ما لديها.
مرارة عدم السؤال:
وفي حادثة التأبير الشهيرة ، نجد أن كارثة حدثت نتيجة عدم السؤال! ومختصر ما حدث هو أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مر بقوم يؤبرون النخل (يلقحونه)، فقال لهم “لو لم تفعلوا لصلح”. فالنبي صلى الله عليه وسلم مارس الرعي والتجارة، ولم يكن لديه خبرة في الزراعة، ظن كما يظن الكثيرون منا أن التمر يخرج من تلقاء نفسه دون تدخل بشري. لكن أهل الزراعة يعلمون أن يخرج شيصا (أي رديئا)، ولا بد من التلقيح كي يخرج التمر سليما وحلوا. لم يسأل القوم الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الأمر، بل تركوا تلقيح النخل دون أن يستبينوا، فخرج شيصا! فلما مر بهم لاحقا قال: “ما لنخلكم؟” قالوا: “قلت كذا وكذا”. قال: “أنتم أعلم بأمر دنياكم”. وأمر الدنيا لا يستقيم دون سؤال. والزراعة حتما من الأمور الدنيوية وليست من الغيب الذي لا نقاش فيه، ويؤخذ كما هو. ومن هنا نتعلم أنه كان عليهم أن يسألوا كما سأل الحباب بن المنذر –رضي الله عنه- إذ قال للنبي –صلى الله عليه وسلم- يوم بدر: “أرأيت هذا المنزل، أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟” ولو لم يسأل هذا السؤال، لما اقترح اقتراحه الذكي باحتكار مصادر المياه أثناء الموقعة.
معنى جديد للسؤال:
في سورة الضحى {وأما السائل فلا تنهر} والتفسير المعتاد هو السائل بمعنى الفقير الذي يسأل الناس حاجته. لكن وبالنظر إلى سياق الآيات أرى والله أعلم أن المقصود هو السائل المستفسر. فالله تعالى ذكر ثلاث نعم أنعم بها على نبيه، وبعدها ذكر ثلاثة أوامر تقابل هذه النعم.
1.فهو أواه بعد يتمه، ثم أوصاه ألا يقهم اليتيم.
2. وهداه بعد الضلالة {ووجدك ضالا فهدى}، وفي مقابلها أوصاه بألا ينهر السائل {وأما السائل فلا تنهر}.
3. ووجده عائلا فقيرا فأغناه، ثم أوصاه بأن يحدث بنعمة به ويظهرها.
والنعمة-الوصية الثانية تبين الترابط بين السؤال وبين الاهتداء. فإذا كانت هذه الأزواج الستة نعما ووصايا، فغالب الظن أن المقصود {وأما السائل فلا تنهر} هو السائل المستفسر لا الفقير.
السؤال صفة أهل الجنة!
في الجنة نُنقى من النقائص والصفات الشائهة التي كانت تلزمنا في إقامتنا الأرضية. وأهل الجنة يتساءلون: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ} (المدّثر:39-41). ولو كان السؤال نقيصة، فإنها لا تليق بأهل الجنة المبرئين، ولكان الله خلصهم منها قبل دخولهم. لكنها صفة نيّرة، بأسئلتهم وتفكرهم وصلوا إلى الله، فكيف يحرمهم الله من هذه الصفة؟ مغبون من حرم نفسه من هذه النعمة، ومغبون أكثر من لم يستخدمها ليصل بها إلى معرفة الله.
*كاتبة كويتية