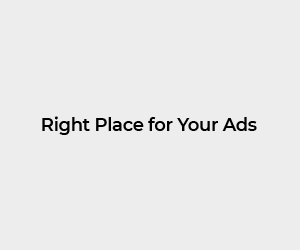الكاتب: يوفال نوح هراري.
ترجمه عن اللغة الإنجليزية:
حافظ إسماعيلي علوي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس/ الرباط.
تواجه الإنسانية اليوم أزمة عالمية، ربما تكون هي الأزمة الأسوأ لجيلنا. من المرجح أن تعمل القرارات، التي سيتخذها الناس والحكومات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على تشكيل العالم خلال السنوات القادمة. لن تُشكِّل نُظم الرعاية الصحية لدينا فحسب، بل ستُشكل أيضا اقتصادنا وسياستنا وثقافتنا. ويجب علينا أن نتصرف بسرعة وبشكل حاسم، كما ينبغي لنا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار عواقب تصرفاتنا على المدى الطويل.
ويتعين علينا حين نختار بين الخيارات المتاحة أن نسائل أنفسنا، ليس فقط عن كيفية التغلب على الخطر الراهن المحدق بنا فحسب، بل أيضا عن أي نوع من العالم سنعيش فيه بمجرد مرور العاصفة. أجل، إن العاصفة ستهدأ، والبشرية ستبقى، وسيظل معظمنا على قيد الحياة، ولكننا سنسكن عالما مختلفا.
ستصبح العديد من تدابير الطوارئ القصيرة الأجل من ثوابت الحياة، وتلك طبيعة حالات الطوارئ. إنها سيرورات تاريخية سريعة التقدم. فالقرارات التي كان الحسم فيها يستغرق سنوات من المداولات في الأوقات العادية تصدر الآن في وقت وجيز. والتكنولوجيات غير الناضجة، حتى الخطيرة منها، تُجنَّد قسرا في الخدمة؛ وذلك لأن مخاطر عدم القيام بأي شيء أدهى وأمر. إن بلدانا بأكملها تشكل، اليوم، حقل تجارب اجتماعية واسعة النطاق. ماذا يحدث عندما يعمل الجميع من المنزل، ويتواصلون فقط عن بعد؟ ماذا يحدث عندما تصبح المدارس والجامعات بأكملها على الإنترنت؟ لن توافق الحكومات والشركات وكذا مجالس التعليم في الأوقات العادية على إجراء تجارب مثل هذه. ولكن الأوقات التي نعيشها اليوم ليست أوقاتا عادية.
إننا في هذا الظرف من الأزمة أمام خيارين هامين اثنين؛ الأول هو اعتماد المراقبة الشمولية وتأهيل المواطنين [وتوعيتهم]. والثاني هو بين العزلة القومية والتضامن العالمي.
المراقبة من تحت الجلد:
يتعين على جميع السكان، من أجل وقف الوباء، الامتثال لمبادئ توجيهية محددة. وهناك طريقتان رئيستان لبلوغ هذا المسعى: أن تُراقب الحكومة الناس، وتُعاقب أولئك الذين لا يمتثلون للتعليمات. لقد أصبح اليوم، ولأول مرة في تاريخ البشرية، بإمكان التكنولوجيا مراقبة الجميع طوال الوقت. لم يكن بوسع جهاز الاستخبارات والأمن الداخلي (KGB) قبل خمسين عاماً، أن يتعقب 240 مليون مواطن سوفياتي على مدار الساعة، ولم يكن بوسعه أن يأمل في معالجة كافة المعلومات التي تُجمع على نـحو فعّال. كانت هيئة الاستخبارات والأمن الداخلي السوفياتية تعتمد على عملاء ومحللين بشريين، ولم يكن بوسعها أن تضع عميلاً بشريا يقتفي أثر كل مواطن على حدة. ولكن بات اليوم بوسع الحكومات الاعتماد على أجهزة الاستشعار عن بعد في كل مكان، وعلى الخوارزمياتalgorithms القوية بدلاً من الطرائق التقليدية المعتادة.
نشرت عدة حكومات -في معركتها لمواجهة وباء فيروس كورونا- أدوات مراقبة جديدة، وتُعَد الصين الحالة الأبرز. فبفضل مراقبة السلطات الصينية لهواتف الناس الذكية بشكل دقيق، والاستفادة من مئات الملايين من الكاميرات التي تتعرف على الوجه، وإلزام الناس بفحص درجة حرارة أجسادهم وحالتهم الطبية وتسجيلها، استطاعت السلطات الصينية أن تحدد بسرعة فائقة حاملي فيروس كورونا المشتبه بهم، وأن تتتبع أيضا تحركاتهم، والتعرف على أي شخص كانوا على تواصل معه، واستعملت في الوقت نفسه مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول لتحذر المواطنين من مخالطة المرضى المصابين.
لا يقتصر هذا النوع من التكنولوجيا على دول شرق آسيا؛ فقد سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً لوكالة الأمن الإسرائيلية بنشر تكنولوجيا المراقبة المخصصة عادة لمحاربة [… المخالفين] لتعقب مرضى فيروس كورونا. وعندما رفضت اللجنة الفرعية البرلمانية المعنية التصريح بتطبيق هذا الإجراء، تصدى لها نتنياهو “بمرسوم طارئ”.
قد يقول قائل: وما الجديد في كل هذا؟ ففي السنوات الأخيرة، كانت كل الحكومات والشركات تستخدم تكنولوجيات أكثر تطوراً لتعقب الناس ومراقبتهم والتلاعب بهم. ولكن إذا لم نتوخ الحذر، فإن الوباء قد يشكل مع ذلك نقطة تحول مهمة في تاريخ المراقبة، ليس فقط لأنها قد تعمل على تطبيع نشر أدوات المراقبة الجماهيرية في البلدان التي رفضتها حتى الآن، بل وأيضاً لأن هذا يعني الانتقال الدرامي من المراقبة “فوق الجلد” إلى المراقبة من “تحت الجلد”.
حتى الآن، عندما يلمس إصبعك شاشة هاتفك الذكي، وتنقر على رابط ما، فإن الحكومة تبتغي أن تعرف بالضبط ما نقَرَ عليه إصبعك. ولكن مع فيروس كورونا، تحولت بؤرة الاهتمام؛ فالحكومة ترغب، الآن في معرفة درجة حرارة إصبعك وضغط الدم تحت الجلد.
وجبة المهلبية السريعة:
من بين المشاكل التي نواجهها في التعامل مع الوضع الذي نقف فيه موقف المراقب أنه لا أحد منا يعرف بالضبط كيف تتم مراقبتنا، وما الذي قد تجلبه السنوات القادمة. إن تكنولوجيا المراقبة تتطور بسرعة فائقة، وما كان يبدو من قبيل الخيال العلمي قبل عشرة أعوام أصبح اليوم خبراً متقادماً. وكتجربة فكرية، لنتأمل هنا حكومة افتراضية تطالب كل مواطن بارتداء سوار بيومتري يراقب درجة حرارة الجسم ومعدل نبضات القلب على مدار الساعة. فالبيانات الناتجة تُحلل بواسطة خوارزميات حكومية. ستعرف الخوارزميات بأمر مرضك حتى قبل أن تعرف أنت ذلك، كما ستعرف أين كنت، ومن قابلت. يمكن تقليص سلاسل العدوى بشكل كبير؛ بل ويمكن حتى اجتثاثها من أوصالها. ويمكن القول بأن هذا النظام يمكن أن يوقف الوباء في مساره خلال أيام. يبدو ذلك رائعًا حقّا، أليس كذلك؟
إن الجانب السلبي هنا، بطبيعة الحال، هو أن هذا من شأنه أن يضفي الشرعية على نظام مراقبة جديد مرعب. فإذا كنت تعلم، على سبيل، المثال أنني قمت بالضغط على رابط فوكس للأخبار بدلاً من رابط سي إن إن، فإن هذا سيعلمك شيئاً عن وجهات نظري السياسية، بل وربما عن شخصيتي. ولكن إذا كنت تستطيع مراقبة ما يحدث لدرجة حرارة جسدي وضغط الدم ومعدل نبضات القلب أثناء مشاهدة مقطع فيديو، فيمكنك معرفة ما يجعلني أضحك، وما يجعلني أبكي، وما يجعلني أغضب حقاً.
هام أن نتذكر أن الغضب والبهجة والملل والحب هي ظواهر بيولوجية تماما مثلها مثل الحمى والسعال. يمكن للتقنية نفسها التي تحدد السعال أن تحدد الضحكات أيضًا. وإذا بدأت الشركات والحكومات في جمع بياناتنا البيولوجية الجماعية، فسوف يكون بوسعها أن تعرف عنا أكثر بكثير مما نعرفه عن أنفسنا، ومن الممكن ألا تتوقع مشاعرنا فحسب، بل أن تتلاعب أيضاً بعواطفنا، وتبيع لنا أي شيء تريده، سواء أكان بضائع أم سياسيين. إن الرصد البيومتري من شأنه أن يجعل تقنيات قرصنة البيانات التي تتبناها كمبريدج أناليتيكا تبدو كأنها شيء من العصر الحجري. ولنتخيل معاً كوريا الشمالية في عام 2030، عندما يتوجب على كل مواطن أن يرتدي سوارا بيومتريا على مدار الساعة. إذا كنت تستمع إلى خطاب من الزعيم العظيم والسوار يلتقط علامات الغضب، فإن أمرك سيكون منتهيا.
يمكنك بالطبع أن تجعل من قضية المراقبة البيومترية إجراء مؤقتا اتخذ خلال حالة الطوارئ، وسوف ينتهي بانتهائها. ولكن الإجراءات المؤقتة تتسم بعادة سيئة تتمثل في تجاوز حالات الطوارئ، خاصة وأن هناك حالة طوارئ جديدة تلوح في الأفق دوما. فقد أعلنت إسرائيل […] على سبيل المثال حالة الطوارئ عام 1948، بررت بها اتخاذ مجموعة من التدابير المؤقتة، بداية من الرقابة على الصحف، ومصادرة الأراضي، إلى فرض ضوابط على إعداد [حلوى] المهلبية […] ولكن بعد انتهاء الحرب لم تعلن إسرائيل قط انتهاء حالة الطوارئ، كما فشلت في إلغاء العديد من التدابير “المؤقتة” في عام 1948 (ألغي مرسوم المهلبية الطارئ في عام 2011).
وحتى عندما تصل العدوى من فيروس كورونا إلى الصِفر، فإن بعض الحكومات المتعطشة للبيانات قد تزعم أنها تحتاج إلى الإبقاء على أنظمة المراقبة البيومترية قائمة لأنها تخشى موجة ثانية من كورونا، أو لأن هناك سلالة جديدة من فيروس إيبولا تتطور في وسط أفريقيا، أو لأن. . . لقد دارت معركة كبيرة في السنوات الأخيرة حول خصوصيّتنا. وستكون أزمة كورونا بمثابة نقطة تحول في المعركة. فحينما يُمنح الناس حرية الاختيار بين الخصوصية والصحة، فإنهم غالبا ما سيختارون الصحة.
شرطة الصابون
إن مطالبة الناس بالاختيار بين الخصوصية والصحة يشكل، في واقع الأمر، السبب الرئيس للمشكلة؛ لأن هذا اختيار خاطئ. وبوسعنا، بل ينبغي لنا، أن نتمتع بالخصوصية والصحة معا. وبوسعنا أن نختار حماية صحتنا ووقف وباء فيروس كورونا، ليس من خلال تأسيس أنظمة مراقبة شمولية، بل من خلال تشجيع المواطنين. من بين الجهود الناجحة الرامية لاحتواء وباء كورونا، في الأسابيع الأخيرة، تلك التدابير التي اتخذتها كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة. فرغم أن هذه البلدان استخدمت بعض تطبيقات التتبع، فإنها اعتمدت بشكل أكبر على الاختبارات المكثفة، والتقارير الصادقة، والاستعداد للتعاون، وكذا على جمهور واسع الاطلاع.
إن المراقبة الشديدة والعقوبات القاسية لا تشكلان الوسيلة الوحيدة لجعل الناس يمتثلون للمبادئ التوجيهية المفيدة. يمكن أن يتحقق ذلك عندما يُخبر الناس بالحقائق العلمية. وحين يثقون في قدرة السلطات العامة على إخبارهم بهذه الحقائق، فإن المواطنين يكونون قادرين على القيام بالتصرف السليم حتى في غياب رقيب يجثم على صدورهم. فالسكان الذين تحركهم دوافع ذاتية ولهم اطلاع واسع عادة ما يكونون أكثر قوة وفعالية بكثير من السكان الذين تحرسهم الشرطة، ومن الجهلة من الناس.
ضع في اعتبارك، مثلا، غسل يديك بالصابون. لقد كان هذا أحد أكبر أوجه التقدم في مجال الصحة البشرية على الإطلاق. إن هذا الفعل البسيط ينقذ أرواح الملايين من البشر كل عام. فبينما نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه، فإن العلماء لم يكتشفوا أهمية غسل اليدين بالصابون إلا في القرن التاسع عشر. وقبل ذلك، فحتى الأطباء والممرضون كانوا يخرجون من عملية جراحية إلى أخرى دون غسل أيديهم. واليوم مليارات الناس يغسلون أيديهم يومياً، ليس لأنهم يخشون شرطة الصابون؛ بل لأنهم يفهمون الحقائق. أنا أغسل يدي بالصابون لأنني سمعت عن الفيروسات والبكتيريا، وأنا أفهم أن هذه الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض، وأنا أعلم أن الصابون يمكن أن يزيل هذه الأمراض.
ولكن لتحقيق مستوى من الامتثال والتعاون، فإنك تحتاج إلى الثقة. يتعين على الناس أن يثقوا في العلم، وأن يثقوا في السلطات العامة، وأن يثقوا في وسائل الإعلام. فطوال السنوات القليلة الماضية، تعمَّد السياسيون غير المسؤولين تقويض الثقة في العلم، وفي السلطات العامة، وفي وسائل الإعلام. والآن قد يستسلم الساسة غير المسؤولين أنفسهم لإغراء سلوك الطريق السريع نـحو التسلط، زاعمين أننا لا نستطيع أن نثق في قدرة عامة الناس على القيام بالتصرف السليم.
وعادة، لا يمكن بين عشية وضحاها إعادة بناء الثقة التي تآكلت طوال سنوات. ولكن هذه الأوقات ليست عادية؛ في وقت الشدة، قد تتغير العقليات بسرعة أيضاً. قد تكون في جدال مع أشقائك لسنين، ولكن عندما يحدث طارئ، فإنك ستكتشف فجأة دَفَقا من الثقة والمودة، وسيهبُّ بعضكم لمساعدة بعض. وبدلاً من بناء نظام رقابة، لم يفت الأوان بعد لإعادة بناء ثقة الناس في العلم، وفي السلطات العامة ووسائل الإعلام. ويتعين علينا بكل تأكيد أن نستخدمها في التكنولوجيات الجديدة أيضا؛ ولكن هذه التكنولوجيات لابد أن تعمل على تشجيع المواطنين. فنحن جميعاً نـحبذ مراقبة درجة حرارة أجسادنا وضغط دمنا، ولكن لا ينبغي استخدام هذه البيانات لإنشاء حكومة ذات صلاحيات مطلقة؛ بل يلزم أن تمكنني هذه البيانات من اتخاذ قرارات شخصية أكثر اطلاعا، فضلاً عن تحميل الحكومة المسؤولية عن قراراتها.
وإذا تمكنت من تتبع حالتي الطبية على مدار الساعة، فلن أتعلم ما إذا كنت قد أصبحت خطراً على صحة الآخرين فحسب؛ بل سأتعلم أيضاً العادات التي تسهم في تحسين صحتي. وإذا تمكنت من الوصول إلى إحصاءات موثوقة عن انتشار فيروس كورونا وتحليلها، فسوف يكون بإمكاني الحكم على ما إذا كانت الحكومة تخبرني بالحقيقة، وما إذا كانت تتبنى السياسات الصحيحة لمكافحة الوباء. وكلما تحدث الناس عن المراقبة، تذكروا أن تكنولوجيا المراقبة نفسها من الممكن استخدامها عادة ليس فقط من قِبَل الحكومات لمراقبة الأفراد؛ بل قد يستخدمها الأفراد أيضا لمراقبة الحكومات.
وبالتالي فإن وباء فيروس كورونا يشكل اختباراً رئيساً للمواطنة. يتعين على كل واحد منا في الأيام المقبلة، أن يختار الثقة في البيانات العلمية وخبراء الرعاية الصحية بشأن نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة والساسة الذين يخدمون أنفسهم. وإذا فشلنا في اتخاذ القرار السليم، فقد نجد أنفسنا بصدد التوقيع على حريتنا الأغلى، لنفكر أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية صحتنا.
حاجتنا إلى مخطط شامل
الاختيار الثاني الهام الذي نواجهه هو بين العزلة القومية والتضامن العالمي. إن الوباء نفسه والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه هما مشكلان عالميان. ولا يمكن حلهما بفعالية إلا من خلال التعاون العالمي.
يتعين علينا، أولاً وقبل كل شيء، للتغلب على الفيروس، أن نتقاسم المعلومات على مستوى العالم. وهذه هي الميزة الكبرى التي يتمتع بها البشر في التعامل مع الفيروسات. ولا يستطيع فيروس كورونا في الصين وفيروس كورونا في الولايات المتحدة أن يتبادلا النصائح بشأن كيفية إصابة البشر. ولكن الصين قادرة على تعليم الولايات المتحدة العديد من الدروس القيمة بشأن فيروس كورونا وكيفية التعامل معه. ما يكتشفه طبيب إيطالي في ميلانو في الصباح الباكر قد ينقذ الأرواح في طهران مساء. وعندما تتردد حكومة المملكة المتحدة بين العديد من السياسات، فإنها تستطيع أن تحصل على المشورة من الكوريين الذين واجهوا بالفعل معضلة مماثلة قبل شهر. ولكن لكي يحدث هذا فنحن في حاجة ماسة إلى روح التعاون والثقة العالميين.
يتعين على البلدان أن تكون على استعداد لتبادل المعلومات علناً وبتواضع، وأن تسعى إلى الحصول على المشورة، وأن تكون قادرة على الثقة في البيانات والمعلومات التي تتلقاها. كما نـحتاج أيضاً إلى جهد شامل لإنتاج المعدات الطبية وتوزيعها، وأبرزها معدات الاختبار وآلات التنفس. وبدلاً من أن تحاول كل دولة القيام بذلك محلياً وتكديس المعدات التي يمكنها الحصول عليها، فإن الجهود العالمية المنسقة من الممكن أن تعمل على التعجيل بعملية الإنتاج إلى حد كبير، والتأكد من توزيع المعدات المنقذة للحياة بشكل أكثر عدالة. وتماماً كما تؤمَّم البلدان الصناعات الرئيسة أثناء الحرب، فإن الحرب الإنسانية ضد فيروس كورونا قد تتطلب منا “إضفاء الطابع الإنساني” على خطوط الإنتاج الحاسمة. إن دولة غنية تعاني من حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا يجب أن تكون على استعداد لإرسال معدات ثمينة إلى دولة فقيرة بها عدد أكبر من حالات الإصابة، على أن تثق في أن الدول الأخرى سوف تقدم لها المساعدة بعد ذلك متى احتاجت إليها.
ويمكنا أن نفكر في جهد عالمي مماثل لتجميع العاملين في المجال الطبي. وبوسع البلدان الأقل تأثراً حالياً أن ترسل موظفين طبيين إلى المناطق الأكثر تضرراً في العالم، لمساعدتهم في وقت الحاجة، ولاكتساب خبرة قيمة. وإذا ما تركز الوباء في وقت لاحق، فإن المساعدة قد تبدأ في التدفق في الاتجاه المعاكس.
هناك حاجة ماسة إلى تعاون عالمي من الناحية الاقتصادية أيضا. ونظراً إلى الطبيعة العالمية للاقتصاد وسلاسل الإمداد، فإذا ما قامت كل حكومة بما هو خاص في تجاهل تام للآخرين، فإن النتيجة سوف تكون الفوضى وتفاقم الأزمة. نـحن في حاجة ماسة إلى خطة عمل عالمية على وجه السرعة.
ثمة مطلب آخر، يتمثل في التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن السفر. إن تعليق كل الرحلات الدولية لأشهر من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات كثيرة، وأن يعوق الحرب ضد فيروس كورونا. ويتعين على الدول أن تتعاون من أجل السماح، على الأقل، لأعداد قليلة من المسافرين الأساسيين بالاستمرار في عبور الحدود: العلماء، والأطباء، والصحافيون، والساسة، ورجال الأعمال. ويمكن القيام بذلك من خلال التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الفحص المسبق للمسافرين من قبل بلدهم الأم. فإذا كنت تعرف أنه يسمح فقط للمسافرين الذين فُحصوا بعناية بالسفر على متن طائرة، ستكون أكثر استعدادا لقبولهم داخل بلدك.
ولكن من المؤسف أن البلدان في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تقوم بأي من هذه الأمور. أمسك الشلل الجماعي بتلابيب المجتمع الدولي. يبدو أنه لا يوجد حكماء بيننا. كان للمرء أن يتوقع قبل أسابيع أن يُعقد اجتماع طارئ لزعماء العالم لوضع خطة عمل مشتركة، غير أن زعماء مجموعة السبع لم يتمكنوا من تنظيم مؤتمر بالفيديو إلا هذا الأسبوع، دون أن يسفر عن أي خطة من هذا القبيل.
في الأزمات العالمية السابقة ــ مثل الأزمة المالية لعام 2008، ووباء إيبولا عام 2014 ــ توَلَّت الولايات المتحدة دور الزعيم العالمي. ولكن الإدارة الأميركية الحالية تخلَّت عن منصب الزعامة ذلك. لقد اتّضح بجلاء أنها تهتم بعظمة أمريكا أكثر مما تهتم بمستقبل البشرية.
لقد تخلت هذه الإدارة حتى عن أقرب حلفائها. وحين حظرت كافة بلدان الاتحاد الأوروبي من السفر، لم تكلف نفسها عناء إعطاء الاتحاد الأوروبي إشعارا مسبقا ـ ناهيك عن التشاور بشأن هذا التدبير الجذري. وقد فضلت ألمانيا بتقديم مليار دولار لشركة أدوية ألمانية لشراء حقوق الاحتكار لمصل جديد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وحتى إذا ما نجحت الإدارة الحالية في النهاية في تغيير الاتجاه فوضعت خطة عمل عالمية، فإن القليل من الناس سوف يتبعون قائداً لا يتحمل المسؤولية أبداً، ولا يعترف بالأخطاء قط، وينسب إليه الفضل في النهاية، بينما يتركون كل اللوم على الآخرين.
وإذا لم تملأ دول أخرى الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، فلن يكون من الصعوبة بمكان وقف الوباء الحالي فحسب، بل إن إرثه سوف يستمر أيضا في تسميم العلاقات الدولية لسنوات قادمة. ورغم هذا فإن كل أزمة تشكل كذلك فرصة. ويجب أن نأمل في أن يساعد الوباء الحالي البشرية على إدراك الخطر المحذق الذي ينجم عن الانقسام العالمي.
يتوجب على الإنسانية أن تختار: هل سننتقل إلى طريق الشقاق، أم سنتبنى مسار التضامن العالمي؟ وإذا اخترنا الانقسام، فإن هذا لن يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة فحسب؛ بل قد يؤدي أيضاً إلى كوارث أشد سوءاً في المستقبل. وإذا اخترنا التضامن العالمي، فسوف يكون نصراً ليس ضد فيروس كورونا فحسب؛ بل وأيضاً ضد كل الأوبئة والأزمات التي قد تجتاح البشرية مستقبلا في القرن الحادي والعشرين.