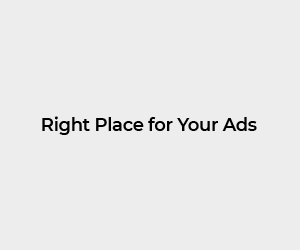في لحظة فارقة من تاريخه الرياضي والسياسي، يجد المغرب نفسه على مشارف حدث كوني استثنائي: تنظيم كأس العالم 2030 بشراكة ثلاثية مع إسبانيا والبرتغال.
لحظة تُقدَّم في الإعلام الرسمي كإنجاز دبلوماسي غير مسبوق، وكفرصة ذهبية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والسياحي، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام. غير أن ما يغيب وسط هذه الأهازيج، هو السؤال الجوهري: من سيدفع الثمن؟ ومن سيجني الثمار؟ وما موقع المواطن المغربي وسط هذه الدينامية التي تتّخذ من الكرة واجهة لبناء صورة الدولة أمام العالم؟
في خضم هذا الزخم، لا يمكن إغفال الدور الحاسم الذي لعبه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تحقيق هذا الحلم الذي راود المغاربة لعقود. فمن خلال جهوده الدبلوماسية، ورؤيته الاستراتيجية، وحرصه المستمر على تعزيز صورة المغرب دوليًا، كان لجلالته الفضل الكبير في نيل شرف تنظيم كأس العالم 2030.
وقد عبّر الملك، في مناسبات عديدة، عن رغبته الملحة في إنجاح هذا الحدث، ليس فقط كاحتفال رياضي، بل كفرصة تاريخية لتعزيز التنمية والانفتاح وتعزيز مكانة المغرب بين الأمم.
الحقيقة التي لا تخفى على المراقبين هي أن تنظيم كأس العالم ليس مجرد احتفالية رياضية، بل مشروع مالي ضخم يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية، من ملاعب وفنادق وطرق وشبكات نقل، إلى تكنولوجيا وأمن ومواكبة إعلامية في بلد يعاني أصلًا من أزمة تمويل، وارتفاع مقلق في المديونية، وتراجع في الخدمات العمومية، يصبح السؤال عن مصدر تمويل هذا المشروع مشروعًا في حد ذاته. فالدولة، في نهاية المطاف، لا تملك إلا جيب المواطن لتمويل طموحاتها الكبرى، سواء عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أو عبر الضغط على النفقات الاجتماعية التي تمس يوميًا حياة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. المواطن هنا لا يُستشار، ولا يُخيَّر، بل يُستغل كقاعدة تمويلية صامتة.
المدافعون عن المشروع يتحدثون بلغة الربح: خلق فرص الشغل، جلب الاستثمارات، انتعاش السياحة، وتحديث المدن. لكن هل هذه الوعود مدعومة برؤية واضحة؟ الواقع والتجارب الدولية تُظهر أن هذه العوائد غالبًا ما تكون ظرفية ومركزة جغرافيًا ولا تطال الشرائح الفقيرة. ففرص العمل التي تُحدثها مثل هذه التظاهرات تكون مؤقتة، مرهونة بأشغال البناء والخدمات، وتختفي مباشرة بعد نهاية الحدث.
أما السياحة، فهي في الغالب لا تنعكس على البنية المحلية، بل يستفيد منها المستثمر الأجنبي والسوق الموجهة نحو الفئات الثرية. وكلما كانت البنية المؤسساتية هشة، كلما تحوّل التنظيم إلى عبء تنموي لا إلى فرصة.
ما يزيد الصورة قتامة هو طريقة تدبير المشاريع الكبرى في المغرب. هناك تاريخ طويل من الفشل، من المشاريع المتعثرة، والميزانيات المنفوخة، والصفقات المشبوهة. لا شيء يبعث على الثقة في أن هذا المشروع سيُدار بمنطق الشفافية والكفاءة. فالحكومة تعاني من ضعف واضح في التخطيط والتنفيذ، ومؤسسات الرقابة تفتقر للاستقلالية، والمحاسبة غائبة تمامًا. نُخب غير منتخبة فعليًا هي من تتحكم في الملفات الكبرى، والقرار يتم بعيدًا عن أعين المواطن، بل حتى عن ممثليه المنتخبين. فكيف لمشروع بهذا الحجم أن يُدار بنجاح في بيئة تغيب فيها الحوكمة الصلبة؟
حتى من الزاوية الرياضية، لا توجد مؤشرات على أن تنظيم المونديال سيُحدث قفزة نوعية. كل ما في الأفق هو استثمارات ضخمة في ملاعب فاخرة، دون خطة حقيقية لتطوير الرياضة من القاعدة. كرة القدم الوطنية تعاني من فساد في الجامعات، وسوء تسيير الأندية، وتغول المال السياسي، بينما الرياضات الأخرى مهمشة بالكامل. لا حديث عن الرياضة المدرسية، أو عن تكوين الأطر، أو عن دعم المواهب في القرى والمناطق المهمشة. الخوف أن يُستعمل المونديال لتجميل الصورة فقط، دون تغيير المنظومة من الداخل، وهو ما يهدد بتحويل هذه الفرصة إلى لحظة دعائية ليس إلا.
ثمّة جانب أكثر خطورة يتعلق بعلاقة الدولة بالمجتمع. المواطن المغربي لا يظهر في خطاب المونديال إلا كممول، كرقم في معادلة اقتصادية، أو كجمهور محتمل في المدرجات. لا وجود لحوار مجتمعي حقيقي حول الأولويات، لا إنصات للمجتمع المدني، لا إشراك للنقابات أو الجامعات أو مراكز البحث. الإعلام الرسمي منشغل بالتطبيل، فيما يُقصى الفاعلون الحقيقيون من أي نقاش عمومي. في غياب الشفافية، يتحول هذا الحدث العالمي إلى ورش مغلق، تُصرف فيه الأموال العمومية بقرارات فوقية، ويُفرض على الناس باعتباره إنجازًا وطنيًا لا يجوز التشكيك فيه.
في العمق، يبدو أن المشروع أقرب إلى تنظيم من أجل التنظيم، لا إلى رؤية استراتيجية تنموية. دون مساءلة، دون ربط المشروع بخطط واضحة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودون ضمان حقوق المواطن في الاستفادة، سيكون الحدث مجرد استعراض عابر يُضاف إلى أرشيف الإنجازات الرسمية، بينما تستمر الأوضاع في التدهور. لن يستفيد المغرب من المونديال إلا إذا أُعيد بناء العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الشفافية، والعدالة، والمسؤولية المشتركة.