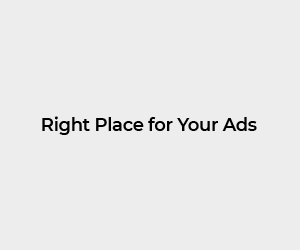يشهد المغرب تآكلًا متزايدًا في منسوب الثقة في المؤسسات، سواء كانت منتخبة أو إدارية، وهو ما تعكسه بوضوح الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي.
فقد أظهرت نتائج حديثة أن نسبة كبيرة من المغاربة لا يثقون في البرلمان والحكومة، بينما تصل نسبة عدم الثقة في الأحزاب السياسية إلى مستويات مقلقة.
حتى النقابات، التي يُفترض أن تمثل المطالب الاجتماعية، لم تسلم من هذا التراجع، إذ أفاد أغلب المشاركين في الاستطلاعات بعدم ثقتهم بها.
هذه المعطيات تعكس أكثر من مجرد لحظة ظرفية من الغضب أو الشك، بل تشير إلى أزمة ثقة بنيوية تمتد جذورها إلى نمط اشتغال المؤسسات ذاتها، وإلى الفجوة المتزايدة بين وعود النخب وواقع المواطنين.
فعندما تصبح المؤسسات غير قادرة على التفاعل الفعّال مع حاجيات الناس أو التعبير عن إرادتهم، تتآكل شرعيتها في الوعي الجماعي، ويحل محلها شعور عام باللامبالاة أو الارتياب.
ويترجم ذلك في ضعف المشاركة السياسية، حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن فقدانهم الثقة في الانتخابات كأداة للتغيير.
ولا يقتصر الأمر على المؤسسات المنتخبة. فحسب نتائج أحد الاستطلاعات، عبّر أغلب المشاركين عن ضعف معرفتهم بصلاحيات البرلمان، فيما أقر آخرون بعدم معرفتهم بكيفية التصويت على القوانين.
هذا الجهل لا يمكن قراءته فقط كإخفاق في التربية المدنية، بل كعلامة على غياب ثقافة التواصل المؤسساتي.
فالمؤسسات لا تبذل جهدًا كافيًا في شرح عملها أو تبرير قراراتها، وهو ما يعمق من الإحساس بانفصالها عن المواطن، ويزيد من الشعور بأن القرار العمومي يتم بعيدًا عن الرقابة أو المشاركة.
في هذا المناخ، تكتسب الخطابات الشعبوية والتكنوقراطية جاذبية متزايدة، لأنها تعد بالحلول السريعة دون الحاجة إلى المرور عبر قنوات التمثيل التقليدية.
هذا التحول في المزاج العام لا يخلو من دلالات خطيرة، خصوصًا حين يُنظر إلى مؤسسة مثل الملكية باعتبارها “المؤسسة الوحيدة التي تشتغل”، مما يضع كل الثقل الرمزي والوظيفي في كفة واحدة، ويجعل باقي المؤسسات تبدو عديمة الفعالية أو مجرد ديكور سياسي.
غياب الثقة لا يقتصر أثره على المشاركة السياسية، بل يمتد ليهدد الاستقرار العام.
فعندما لا تعود المؤسسات مرجعية لحل النزاعات أو لتدبير المصالح، تنفتح الأبواب أمام أشكال بديلة من التعبير، بعضها يأخذ طابعًا احتجاجيًا غير مؤطر، ويصعب ضبطه أو احتواؤه.
وقد أثبتت تجارب سابقة أن غياب الوساطة المؤسساتية يفرز حالات من التوتر الاجتماعي المتصاعد يصعب احتواؤها بالآليات التقليدية.
ترميم هذه الثقة لا يمكن أن يتحقق عبر الترميمات الشكلية أو التغييرات التقنية المحدودة، بل يتطلب مراجعة عميقة وشجاعة لنمط اشتغال الدولة، ولموقع المواطن داخل المنظومة السياسية، باعتباره شريكًا في صناعة القرار، لا مجرد متلقٍ أو متفرج.
فالمطلوب ليس فقط مؤسسات تشتغل، بل مؤسسات يُشعر فيها المواطن بأنه ممثل، مسموع، ومؤثّر في مصير الشأن العام.