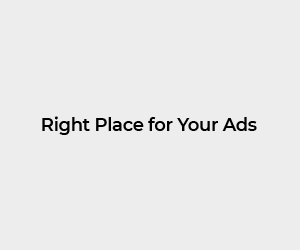لم تكن نتائج الجولة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري (2022) عند توقعات اتجاهات عديدة أمريكية وإسرائيلية قبل بدايتها. وربما يمكن القول إن النتيجة الأهم لهذه الجولة تمثلت في أنها كشفت أنه أصبحت هناك ضوابط جديدة تحكم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الرئيسية في المنطقة. فقد نجح قادة الدول العربية المشاركون في القمة في توجيه رسائل مباشرة بشأن الأسس الحاكمة لسياساتها الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الرئيسية بالإقليم، سواء القضية الفلسطينية، أو العلاقات مع إيران، أو الحرب الروسية-الأوكرانية، فضلاً عن حدود العلاقات مع إسرائيل التي سعت إلى استثمار الزيارة بما يتوافق مع حساباتها إزاء المواجهة مع إيران والتطبيع مع بعض الدول العربية والموقف من الملف الفلسطيني. وتوازى مع ذلك كله عدم وضوح الرؤية الأمريكية بشكل كافٍ إزاء تلك القضايا، على نحو طرح تساؤلات أكثر ما قدم من إجابات حول ما الذي خرجت به الولايات المتحدة الأمريكية فعلاً من هذه الجولة؟
القضية الفلسطينية: تساؤلات بحاجة إلى إجابة
بالرغم من التراجع الواضح فى القضية الفلسطينية وبرغم اتفاقات التطبيع الإسرائيلى العربى الأخيرة التى قفزت على هذه القضية المحورية، إلا أنه لابد من التوقف كثيراً عند موقف القيادات العربية خلال قمة جدة للأمن والتنمية التى انتهت أعمالها يوم 16 الجارى، حيث ضربت هذه القيادات أروع المواقف عندما أكدت أن القضية الفلسطينية سوف تظل القضية المركزية العربية وأن المطلوب هو التوصل إلى حل عادل ودائم يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية.
ولعل أهم جانب فى هذا الموقف تمثل فى أنه كان بمثابة رسالة قوية تم توجيهها إلى الرئيس الأمريكى الذى أنصت بتركيز شديد لهذه الرسالة وأصبح على قناعة بأنه لا يمكن لزعيم عربى أن يتخلى عن هذه القضية مهما كان حجم المخاطر فى المنطقة أو التطورات الجارية فى مجال التطبيع الإسرائيلى العربى.
وللإنصاف، لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابى فى اللقاء الذى جمع الرئيس بايدن مع الرئيس أبو مازن فى الضفة الغربية وتأكيده صراحة على دعمه المتواصل لحل الدولتين، إلا أن هذا الموقف الأمريكى أصبح غير ذى فاعلية وتم تفريغه من مضمونه فى ضوء ما أوضحه بايدن بأن الوقت الحالى غير مناسب لاستئناف المفاوضات كما أنه لن يتراجع عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وارتباطاً بهذه الزيارة الهامة للمنطقة، يمكن توجيه سبعة أسئلة إلى الرئيس الأمريكى وهى كما يلى:
السؤال الأول: ماهو الجديد فى الموقف الأمريكى تجاه القضية الفلسطينية أكثر من التأكيد على مبادئ سبق أن تم التأكيد عليها من قبل؟.
السؤال الثانى: هل زيارة الرئيس الأمريكى للضفة الغربية تمخضت فقط عن هذا التأكيد المعروف؟ أم أن الأمر كان يتطلب أن تكون لها نتائج أعمق؟
السؤال الثالث: هل الولايات المتحدة أصبحت عاجزة عن طرح أية خطوات لتغيير الواقع الحالى فى القضية مثل الإعلان عن قرار استئناف المفاوضات فى مرحلة ما حتى فى أعقاب الانتخابات الإسرائيلية المقررة فى نوفمبر 2022؟.
السؤال الرابع: هل يعتقد الرئيس الأمريكى أن السلام الإقتصادى وحده يمثل الأمل لدى الفلسطينيين مهما كان حجم المساعدات المقدمة لهم بينما يعلم الجميع أن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا السلام؟.
السؤال الخامس: هل هناك أى قدر من التوازن بين ما قدمه بايدن لإسرائيل والذى تبلور فى “إعلان القدس” وبين ما لم يقدمه للفلسطينيين الذين هم فى حاجة إلى موقف يبعث لديهم بعض الأمل؟
السؤال السادس: ما هو الوقت المناسب من وجهة النظر الأمريكية لتنفيذ مبدأ حل الدولتين؟، وهل تتنظر واشنطن استكمال مخططات الاستيطان والتهويد الإسرائيلى حتى تتحرك؟.
السؤال السابع: ما هى الرسالة التى يمكن أن يستخلصها الشعب الفلسطينى فى أعقاب انتهاء زيارة بايدن أكثر من أن كل التركيز قد انصب على أمن إسرائيل وتحقيق المصالح الأمريكية فى المنطقة، أما الفلسطينيين فعليهم أن يبحثوا عن حلول أخرى بمعرفتهم؟.
ومع كل التقدير لزيارة بايدن للضفة الغربية، إلا أن الواقع يشير إلى أن القضية الفلسطينية لم تتحرك قيد أنملة، بل إن هذا الموقف الأمريكى سوف يشجع إسرائيل على تنفيذ كافة مخططاتها فى القدس والضفة الغربية دون أن تعبأ بمواقف عامة لا تحمل فى طياتها أية آليات جادة لتحريك الوضع الراهن. ورغم صعوبة هذا الوضع، إلا أن التحرك لازال ممكناً وكما أوضح أبو مازن أن حل الدولتين قد يكون متاحاً الآن ولكنه لن يكون متاحاً بعد ذلك وهى كلمات يجب أن يقف الجميع أمامها.
وفى النهاية، فإن المطلوب أمريكياً وعربياً البحث من الآن عن فرصة لاستئناف المفاوضات قبل نهاية العام الحالى، وبالتوازى مع ذلك فإن الإدارة الأمريكية مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لصالح الفلسطينيين أهمها إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب وإعادة فتح مكتب المنظمة فى واشنطن، أما دون ذلك فإن التقييم الإجمالى لزيارة بايدن يندرج تحت عنوان واحد وهو تأكيد الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل وتمهيد المجال أمام مزيد من اتفاقات التطبيع، أما مسألة العودة لملء الفراغ فى المنطقة فإنها مقولة مردود عليها بأن الولايات المتحدة لم تنسحب من المنطقة حتى تعود إليها.
هل تغيرت الرؤية الإقليمية للسياسة الأمريكية بعد الجولة؟
على الرغم من أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط أعادت التأكيد على الالتزام بأمن الشركاء في الشرق الأوسط، إلا أنها لم تبدد مرحلة الفتور والشكوك في نوايا الادارة الأمريكية تجاه هذا الالتزام التقليدي. فمن الناحية العملية، يمكن القول إن هناك خطوطاً متوازية فى السياسة الأمنية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، فأولوية البعد الجيوستراتيجي للمنطقة تمثل ركناً أساسياً في المنظور الأمريكي لإعادة الانتشار العسكري في العالم، في مواجهة روسيا والصين، وكحلقة وصل ما بين أساطيلها المنتشرة في العالم، ما بين المحيطين الهندي والهادي، مع توظيف دور هذا الانتشار مناطقياً لقطع الطريق على محاولة القوى الدولية استغلال الغياب الأمريكي عن الشرق الأوسط وملء الفراغ فيه، ثم تأتي مصالح الشركاء في المنطقة بطبيعة الحال.
ووفق تحليل مشاهد زيارة بايدن، فإن تلك المصالح ليست في مستوى واحد، إذ لا يمكن المقارنة بين مشهد استعراض بايدن لمنظومات الدفاع في مطار “بن جورين” بإسرائيل والتي ستمول واشنطن استكمال مشروع تطويرها، سواء تكنولوجياً فيما يتعلق بمنظومات الليزر، أو دعم النظام الدفاعي متعدد الطبقات، وبين المشهد في قمة الأمن والتنمية في جدة، والتي يمكن اعتبارها قمة “دبلوماسية” في المقام الأول أكثر من كونها قمة أمنية، من حيث الرهان الأمريكي على تهدئة وخفض مستوى الصراعات، فى اليمن وسوريا، ودعم العملية السياسية في كل من ليبيا والعراق والسودان ولبنان، مع الوضع فى الاعتبار أن قوة المهام المشتركة التي تمت الإشادة بها خلال القمة (159– 53) هي بالفعل جزء من عملية الانتشار الجديد في إطار تطوير دور وتمدد انتشار القيادة الوسطى الأمريكية من الخليج إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
في واقع الأمر، لا توجد ضمانات للإبقاء على التهدئة في الكثير من الساحات التي تشهد صراعات، كالحالة اليمنية، التي تعد الحالة الرئيسية الآن في هذا السياق، فقد هدد الحوثيون في اليمن على التوازي مع القمة بعدم الاستمرار في الهدنة، وهو ما يتماشى مع الموقف الإيراني الرسمي. وقد لا يكون موقف الحوثيين المعلن موقفاً نهائياً رغم التشديد عليه، لكن من المؤكد أن المليشيا تطالب برفع مستوى مكاسبها من الهدنة، بما يعد نوعاً من الابتزاز السياسي، وبالتالي فالأمر لا يتوقف على القدرة على ردع الحوثيين إذا ما عادت الأمور إلى التصعيد وانهارت الهدنة.
من جهة أخرى، هناك لغة مختلفة بين إيران والدول العربية، فالسعودية تشير إلى “الجارة” إيران، والأخيرة تتحدث عن “الأجواء” الإيجابية في الحوار مع السعودية، والانفتاح على “الأشقاء”، وبالتالي أصبحت هناك رهانات مختلفة بين كافة الأطراف على الأقل تحقق الحد الأدنى المطلوب للتهدئة مرحلياً. ومع ربط هذا السياق بما أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من وجوب وضع خطة للاستعداد لحرب في المنطقة، وأن ثمة تخطيطاً مشتركاً مع الجانب الأمريكي في ضوء لقائه مع قائد “سنتكوم” الجنرال مايكل كوريلا لدى زيارته إلى تل أبيب عقب القمة – وهي زيارة مسبقة الترتيب – يمكن القول إن هذا التخطيط سوف يظل على المستوى الثنائي.
في السياق ذاته؛ يمكن قراءة الموقف الخاص بعلاقة إسرائيل بهذا التطور، اذ تم التأكيد خلال القمة من جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأنه لا تعاون عسكري سعودي – إسرائيلي، وهو ما لا يتعارض مع التطور الخاص بتنامي الحضور الإسرائيلي عسكرياً في المنطقة، بعد أن أصبحت إسرائيل عضواً فى القيادة الوسطى الأمريكية “سنتكوم”، التي تتولي تنظيم وتنسيق العلاقة بين الشركاء، فالأجواء أصبحت مفتوحه للطيران الإسرائيلي، للوصول إلى مناطق عمل “سنتكوم”، وبالتبعية أغلق ملف “الناتو العربي”، وهناك تصريحات مصرية وسعودية متواترة حول هذا الأمر. ومن الناحية الشكلية، لا يمكن اعتبار التنسيق بين بعض الدول في إطار عمليات الدفاع الجوي لاعتراض محاولات هجوم إيرانية – وفق الرواية الإسرائيلية – تحالفاً، بما لا ينفي تنامي العلاقات الأمنية على المستوى الثنائي بين إسرائيل وبعض الأطراف العربية، على نحو يعد تطوراً سواء على مستوى الشراكة العلنية، أو على صعيد كثافة هذه العلاقات التي تقوم على أساس برجماتي.
كيف قرأت إيران جولة بايدن؟
إن كل ما سبق كان محل قراءة متأنية بالطبع من جانب إيران، التي راقبت، كغيرها، جولة الرئيس الأمريكي بهدف تقييم المعطيات الجديدة التي يمكن أن تفرضها على الساحة الإقليمية، لاسيما على صعيد المواجهة المستمرة بينها وبين إسرائيل، أو على مستوى تعزيز التعاون بين الأخيرة والعديد من الدول العربية، على نحو ترى أنها المستهدف الأول منه.
وفي الواقع، فإن إيران اعتبرت أن الجولة لم تضف جديداً للمعطيات القائمة أصلاً في منطقة الشرق الأوسط. فالمواجهة على أشدها بينها وبين إسرائيل، في ظل العمليات الاستخباراتية التي تقوم بها الأخيرة داخل إيران نفسها، واستهدفت من خلالها المنشآت النووية والعسكرية فضلاً عن العلماء النوويين وبعض القيادات في “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري. وتوازى معها ضربات عسكرية إسرائيلية متتالية ضد مواقع إيران والنظام السوري وحزب الله داخل سوريا.
كما أن تطوير العلاقات بين إسرائيل والدول العربية أو بمعنى أدق الجهود التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف قائمة بالفعل، حتى من قبل أن يفكر الرئيس الأمريكي في إجراء الجولة.
من هنا، ورغم التهديدات التي أطلقتها إيران بالتوازي مع زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل، وتوقيعه “إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل” في 14 يوليو الجاري، فإنها في النهاية قامت بتقييم الجولة على أنها لم تحقق الهدف الأساسي منها.
ووفقاً لها، فإن السبب الأساسي في الجولة كان اقتصادياً، ويتعلق تحديداً بإقناع بعض دول المنطقة بزيادة إمدادات الطاقة في الأسواق الدولية، لاسيما المملكة العربية السعودية، وبالتالي، فإن المواجهة معها لم تكن هى العنوان الرئيسي لهذه الجولة رغم كل الضغوط التي تعرضت لها إدارة الرئيس الأمريكي من جانب إسرائيل ورغم الحملة القوية التي شنتها الأخيرة قبل وأثناء الجولة في هذا السياق.
لكن الأهم من ذلك، في الرؤية الإيرانية، هو أن ما تم الترويج له مع بداية الإعلان عن إجراء الجولة من أن الهدف الأساسي لها يتمثل في صياغة ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل وبعض الدول العربية مناوئة لطموحات إيران النووية والإقليمية، ثبت أنه لا يتسامح مع المعطيات الموجودة على الأرض، التي أكدت أن ذلك كان مبالغاً فيه من البداية، واعتبر محاولة من جانب إسرائيل أولاً لإجراء تغيير في أولويات الجولة، وثانياً لممارسة ضغوط على الرئيس الأمريكي قبل إجراءها، من أجل عدم الانخراط في ملفات ترى إسرائيل أنها “مؤجلة” على غرار الدعوة إلى استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين أو اتخاذ خطوات أكبر تجاه الفلسطينيين أكثر من تأكيد دعم “حل الدولتين”.
وبناءً على ما سبق، فإن إيران سوف تتعامل، في الغالب، في مرحلة ما بعد انتهاء الجولة وفق مسارات رئيسية ثلاثة: أولها، مواصلة إدارة التصعيد مع إسرائيل، التي لا يبدو أنها سوف تتراجع عن خططها وعملياتها الحالية داخل إيران وخارجها أياً كان المسار الذي سوف تنتهي إليه المفاوضات مع القوى الدولية حول الاتفاق النووي. وربما يكون الحلفاء هم الطرف الأساسي خلال المرحلة القادمة، خاصة حزب الله اللبناني، الذي وجه من الرسائل ما يفيد أنه مستعد للانخراط فيها، لاسيما في حالة ما إذا تجاوزت المستوى الذي سبق الجولة.
وثانيها، ربط أى تطورات محتملة في بعض الملفات بما سوف تشهده المفاوضات النووية أو الحوارات الجارية مع بعض الدول العربية، لاسيما السعودية. ومن دون شك، فإن الملف اليمني سوف يكون في الصدارة، خاصة أنه حظى باهتمام خاص من جانب إدارة بايدن خلال الجولة، حيث اعتبرت الإدارة أن السياسة الأمريكية كان له دور في تمديد الهدنة القائمة حالياً في اليمن. وهنا، فإن موعد 3 أغسطس القادم سوف يكون اختباراً واضحاً لهذه المقاربة الإيرانية، ولرؤية إيران للمسارات التي يمكن أن تتجه إليها المفاوضات النووية والحوارات الإقليمية.
وثالثها، تعزيز التعاون مع كل من روسيا والصين. ورغم أن هذا المسار قائم قبل إجراء الجولة، إلا أنه قد يشهد مزيداً من الخطوات الإجرائية على الأرض، خاصة بعد الرسائل التي وجهتها إيران وروسيا وتركيا خلال القمة الثلاثية التي عقدت في طهران، في 19 يوليو الجاري، بين الرؤساء الروسي فيلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.
خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس العلاقة بين الإقليم والنظام العالمي
تختلف العلاقة مع النظام العالمي من إقليم إلى آخر. بعض الأقاليم نجحت في وضع حدود واضحة بين نظامها الإٍقليمي والنظام العالمي، دون أن ينفي ذلك بالتأكيد قدرة القوى الكبرى على التأثير على السياسات الإقليمية، بحكم وضعها على قمة النظام العالمي، وما تمتلكه من قدرة على التأثير في صناعة السياسات الإقليمية. على العكس من ذلك، مثل إقليم الشرق الأوسط حالة مغايرة، فقد ظلت العلاقة أو الحدود بين النظام الإقليمي والنظام العالمي، والقوة/ القوى المهمنة على النظام، غير واضحة، وظلت الأخيرة تمتلك قدرة غير محدودة على التدخل في الإقليم، بما في ذلك التدخل العسكري. وظلت قدرة النظام الإقليمي على ضبط هذه الحدود أو الهيمنة على السياسات الإقليمية محدودة، على حد دفع البعض إلى اعتبار القوى المهيمنة على النظام العالمي أحد الفاعلين الإقليميين الرئيسيين في إقليم الشرق الأوسط.
إحدى النتائج المهمة لقمة جدة أنها مثلت حدثاً كاشفاً عن تحول مهم في نمط العلاقة بين الشرق الأوسط والقوة المهيمنة -حتى الآن- على النظام العالمي، وقدمت نموذجاً مهماً لقدرة القوى العربية الرئيسية بالإقليم على ضبط العلاقة مع القوة العظمى، على نحو يشير أولاً إلى قراءة دقيقة للقوى العربية الرئيسية لطبيعة اللحظة الراهنة في النظام العالمي. ويشير ثانياً إلى قدرة القوى العربية على توظيف ما لديها من أوراق -اقتصادية وسياسية ودبلوماسية- لضبط العلاقة مع الولايات المتحدة، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا التنسيق غير المسبوق فيما بينها.
هناك عدد من المؤشرات التي تدعم هذا الاستنتاج، نطرحها فيما يلي:
المؤشر الأول، يتعلق بعدم استحضار الصراع الأمريكي مع كل من روسيا والصين؛ فرغم هيمنة هذا الصراع على السياسات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا الصراع لم يكن حاضراً بشكل واضح في القمة، وغابت أية إشارات إليه في البيان الختامي. وحتى عندما أشار البيان إلى الحرب في أوكرانيا، فقد اكتفى بالتأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بعد استخدام القوة أو التهديد بها. كما حث البيان المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ودعم الأمن الغذائي للدول المتضررة. بمعنى، آخر، وعلى العكس من تصريح بايدن (إننا) “سنسعى لتعزيز تواجدنا في المنطقة حتى لا نترك فراغاً تملؤه الصين وروسيا”، فقد تجنب البيان أية إشارة إلى إدانة السلوك الروسي، أو وصف هذا السلوك بالعدوان. كما غابت أية إشارات مباشرة ذات صلة بالصين، وذلك باستثناء الإشارة إلى “الدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين”، أخذاً في الاعتبار أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الإندو-باسيفيك) باتت المسرح الأهم للصراع بين الولايات المتحدة والصين. لكن مع ذلك فإن استحضار مسرح “الإندوباسيفيك” لم يرتبط به أية إشارات سلبية أو صراعية مع الصين.
هذا الغياب الواضح للصراع الأمريكي الراهن مع روسيا والصين عن البيان، رغم الإشارات إليهما في تصريحات أمريكية فردية، يشير إلى إدراك الولايات المتحدة أن هناك حدوداً حقيقية للأحادية الأمريكية في الإقليم، وأنه لم يعد هناك “فراغ قوة” أو “فراغ استراتيجي” بالإقليم بالمعنى الذي تصورته إدارة بايدن، وأن دول المنطقة باتت تمتلك علاقات قوية مع باقي الأطراف (روسيا والصين). فقد نجحت الدول العربية الرئيسية في تطوير وتنويع علاقاتها مع هذه القوى في مجالات عدة (الطاقة، الاقتصاد، السلاح)، على نحو لم يعد من الممكن إعادتها إلى عقود سابقة، رغم أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة، خاصة بعد الإشارات والخبرات السلبية لدول المنطقة مع “الحليف” الأمريكي في عهد إدارة ترامب، وحدود الاعتماد على هذا الحليف. ومن ثم، فإن البديل العملي المتاح الآن لدى الولايات المتحدة الآن هو حجز موقع لها في الإقليم، وليس قطع الطريق على قوى أخرى، أو إجبار دول المنطقة على التعامل مع القوى الكبرى بمنطق “المباراة الصفرية”.
خلاصة القول، هنا إن القمة -في حدود ما كشف عنه بيانها الختامي- دشنت، أو كرست (إلى حد كبير) حالة تعددية الأطراف في الإقليم، بحيث لم تعد الولايات المتحدة هي القوة العظمى المهيمنة على شئون الإقليم، بقدر ما أضحت واحدة من القوى الدولية العديدة، وهو ما يشير إلى نجاح القوى العربية في استغلال حالة السيولة الراهنة في النظام العالمي لإعادة ضبط العلاقة بين الإقليم والقوى الكبرى.
المؤشر الثاني، هو نجاح الدول العربية في “ضبط” الأفكار/ التوجهات أو الطموحات الأمريكية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية بالإقليم. ونشير فيما يلي إلى ثلاثة قضايا رئيسية:
الأولى، هي المتعلقة ببناء ترتيب أمني إقليمي؛ فرغم أن جولة بايدن قد سبقها اقتراح الكونجرس الأمريكي إقامة نظام دفاع صاروخي، من خلال الربط بين أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل ودول عربية، بهدف التعامل مع “التهديد الإيراني”، والذي وصل إلى حد الحديث عن بناء “ناتو شرق أوسطي”، لكن القوى العربية نجحت في “ضبط” هذا التوجه الأمريكي، ووضع سقف له، حتى قبل أن يبدأ بايدن جولته. ولا يدحض من دقة هذا الاستنتاج ما جاء في “إعلان القدس” الصادر عن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي (14 يوليو 2022) من التزام الولايات المتحدة “بمواصلة لعب دور نشط…. في بناء هيكل إقليمي قوي robust regional architecture؛ لتعميق العلاقات بين إسرائيل وجميع شركائها الإقليميين، لدفع التكامل الإقليمي لإسرائيل مع مرور الوقت، وتوسيع دائرة السلام لتشمل المزيد من الدول العربية والإسلامية”؛ إذ يحمل تعبير “هيكل إقليمي” المستخدم في البيان طابعاً سياسياً أكثر منه طابعاً أو بعداً عسكرياً.
كما لا يدحض من الاستنتاج نفسه أيضاً، وكما سبق القول، إنشاء “قوة المهام المشتركة 153″، و”قوة المهام المشتركة 59″، بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المركزية، خاصة في مجال رصد التهديدات البحرية وتطوير الدفاعات البحرية، إذ لا ترتبط هذه المهام بفكرة إنشاء ترتيب دفاعي إقليمي بقدر ما ترتبط بمسألة إعادة الانتشار العسكري الأمريكي، وبتطوير التنسيق والتعاون الدفاعي القائم بالفعل بين الطرفين، خاصة في ضوء تصاعد أنماط التهديدات البحرية.
الثانية، ضبط التوجهات الأمريكية فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية. فقد اتفقت العديد من التقديرات قبل بدء جولة بايدن على أن أحد الأهداف الأساسية للجولة هو تعبئة دول المنطقة -سياسياً إن لم يكن عسكرياً أيضاً- ضد “التهديد” الإيراني. لكن هذا لم يحدث من الناحية العملية. فبالإضافة إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض مشروع “الترتيب الأمني الإقليمي”، جاء تناول المسألة الإيرانية متوافقاً مع المدخل المصري والعربي التاريخي إزاء قضية الانتشار النووي في المنطقة، حيث أعلن البيان دعم “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، ودعوة إيران “للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل”. أضف إلى ذلك ترحيب البيان بـ”الدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة”، في إشارة ضمنية للحوار الجاري بين المملكة العربية السعودية وإيران بوساطة عراقية. بمعنى آخر، ورغم الأزمة التي لازالت تواجه العودة إلى العمل بالاتفاق الموقع مع إيران في عام 2015 بشأن برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة قد انحازت في النهاية إلى النهج الإقليمي كما تعبر عنه مواقف القوى العربية الرئيسية، سواء فيما يتعلق بقضية الانتشار النووي بشكل عام في المنطقة، أو فيما يخص مسار الحوار الجاري مع إيران.
الثالثة، تتعلق بنجاح القوى العربية في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بإعادة التأكيد عليها كقضية مركزية في الإقليم، أو فيما يتعلق بالمرجعيات الأساسية التي يجب أن تحكم المقاربات الأمريكية والدولية بشأن القضية، وعلى رأسها مبدأ حل الدولتين. ورغم عدم وجود أفق لبدء مفاوضات أو عملية تسوية حقيقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، ووجود العديد من التساؤلات التي لازالت تبحث عن إجابات عقب قمة جدة، على نحو ما تم الإشارة إليه سابقاً، لكن التأكيد على مبدأ حل الدولتين في حد ذاته مثل خطوة مهمة لسحب الشرعية من بعض المقاربات التي رفضتها السلطة الفلسطينية والقوى العربية.
خلاصة القول، لقد مثلت القمة خطوة مهمة في اتجاه إعادة صياغة العلاقة بين الإٍقليم والولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة -حتى الآن- على النظام العالمي، وتأسيس جديد لهذه العلاقة. كما مهدت الطريق لخلق حالة تعددية أطراف في الإقليم. لكنها (القمة)، وما نتج عنها من مخرجات مهمة، لا تمثل بأي حال من الأحوال شرطاً كافياً للوصول إلى هذا الهدف. إن الوصول إلى حالة تعددية أطراف حقيقية في الإقليم تعزز المصالح العربية، تتطلب جهوداً إضافية عديدة، سواء على مستوى العلاقات العربية- العربية، أو العربية- الأمريكية.
بقلم..اللواء/ محمد إبراهيم – د. محمد فايز فرحات – د. محمد عباس ناجي – أحمد عليبه