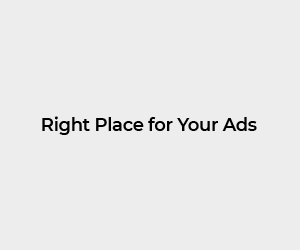الحدث بريس : الصادق عمري علوي.
شهد المغرب خلال فترات تاريخه الطويل العديد من “الجوائح ” والتي تحولت بفعل قوتها الضارية ، الضاربة لكوارث بسبب انتشار التلوث و التعفن بجميع أشكاله ، لينتقل مباشرة لتهديد الحياة الصحية للإنسان في محيطه كوباء .
تلك الجوائح قد تعبر القارات الخمس آتية من مناطق بعيدة استفحلت بها الحروب والكوارث البيئية والتعفن – كما هو الحال الآن بالنسبة لوباء كرونا المستجد – ليسري بمختلف الطرق ناقلا للعدوى بين البشر عبر العالم وقد يكون الوباء محليا بفعل عدم احترام الإنسان لمحيطه البيئي ، وسعيه دون أن يشعر بإحداث اختلال بالنظام الطبيعي .
وقد أطلق عليها علماء الطب القدامى “الجوائح ” أو” الأوبئة ” هؤلاء الذين قسموها في مصنفاتهم الطبية إلى ثلاث أصناف مائية ، وهوائية ، وأرضية ، وسماوية .. كانحباس المطر .. وهبوب الرياح الشديدة من جهات معينة بشكل مفرط ناقلة في مسارها زخم انتشار التعفن من فضاءات تنتشر بها الجثث الحيوانية الميتة الملقاة بالمياه الراكدة ، الآسنة أو بالأراضي الرطبة العطنة التي عمتها كثرة الحروب وتراكمت وتكومت واختلطت وتفاعلت بها جثث البشر الملقاة دون دفن … وقالوا بأن وقوع ذلك دليل على سريان وقدوم الوباء لامحالة .
من المؤرخين المسلمين الذين قدموا صورة عن بعض من تلك الجوائح القاسية التي مر منها المغرب الأديب والمؤرخ أحمد بن خالد الناصري في كتابه المشهور الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (أي الدول التي تعاقبت على حكم المغرب ) فقد قدم وصفا دقيقا لتلك الجوائح وخاصة في الجزء التاسع من مجلداته قائلا ” ففي سنة ثلاث وثمانين ومأتين وألف هجرية ( 1283) ” كان بالمغرب جراد سد الأفق وذلك في ربيع الأول الموافق لشهر “مارس العجمي” ، فأكل النجم والشجر ،ثم عقبه فرخه المعروف بآمرد فأكل كل خضراء على وجه الأرض واستلب الأعواد من أوراقها وقشرها من لحاها وفاض في الأمصار حتى دخل على الناس في بيوتهم …” ” وفي سنة خمس وثمانين ومأتين وألف (1285 ) كان الوباء بالمغرب بالقيء والإسهال المفرطين ” ص 121 .
” وفي سنة تسعين ومأتين وألف ( 1290 ه ) كانت جائحة النار بكثير من بلاد المغرب أحرقت الزروع ، والثمار وأجيحت الجنان ، وتراجع الناس في أثمان مابيع منها ، بعد إثبات الموجبات وكانت أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان في أولها شديدة بسبب ظهور العدو على المسلمين وما عقبه من الغلاء والموت ، ثم بعد ذلك اتسع الحال وحصل الأمن وانخفظت شوكة قبائل العرب بالمغرب وأمنت الطرقات من عيهم وازدهت الدنيا ورخصت الأسعار رخصا يسيرا وكان الناس ممعشين في أيامه …”
ويستمر الناصري في وصفه حتى سنة 1295 ه ليقول ” ثم دخلت سنة خمس تسعين ومأتين وألف فكانت هذه السنة من أشد السنين على المسلمين قد تعددت فيها المصائب والكروب وتلونت فيها النوائب والخطوب … لاأعادها الله عليهم ، فكان فيها غلاء الأسعار … ثم عقب ذلك انحباس المطر لم تنزل من السماء قطرة ، وأجيحت الناس وهلكت الدواب والأنعام ، وعقب ذلك الجوع ثم الوباء على ثلاثة أصناف كانت أولا بالاسهال والقيء في أوساط الناس بادية وحاضرة ط ثم كان بالجوع في أهل البادية خاصة هلك منهم الجم الغفير … فأمر السلطان أعزه الله ( المولى الحسن بن محمد ) أعزه الله عمال الأمصار وأمناءها أن يرتبوا للناس من الأقوات ما ينتعشون به ففعلوا ، وبعد هذا كان حدث الوباء بالحمى في أعيان الناس وأمثالهم فهلك منهم عدد كثير … ” ثم دخلت سنة ست وتسعين ومأتين وألف 1296 هـ فكان موت الناس بالحمى ..” ص 164-165 ج 9
فكان المغاربة يجتازون تلك ” الجوائح ” رغم أثرها البالغ بإيمان وصبر وتضامن جماعي رغم محدودية إمكانياتهم وانعدام المختبرات وقلة الأطباء و المستشفيات والمراكز الطبية الموجودة اليوم ، لكنهم كانوا في غالب الأحيان – حسب الرواية الشفوية لكبار السن – عند انتشار التعفن والتلوث يستعملون الصابون كثيرا في غسل الأيدي … والكافور لتطهير الأماكن في البيت ومنهم من كان يرش بعضا من قطرات القطران أو مستخلص القرنفل ممزوجا بالماء بزوايا المنزل لتنقية الهواء الفاسد وصد الحشرات الناقلة للأمراض … وكذلك كانوا يستعملون الزيوت العطرية النفاذة التي يستخلصونها من الورود والزهور والأعشاب المحلية وما “المرشات النحاسية والفضية ” لرش ماء الورد البلدي وماء الزهر … المعبأ بها والتي انتشرت كعادة في المغرب في تلك الآونة إلا دليل على محاولتهم مواجهة أثر الهواء الفاسد المتعفن وتعقيم محيطهم حفاظا على صحتهم بوسائلهم التقليدية التي قد لا تفي بالغرض ولا ترقى لما نراه الآن من توفر المواد المعقمة للأرض والهواء الفاسدين للحيلولة دون تفشي الوباء .